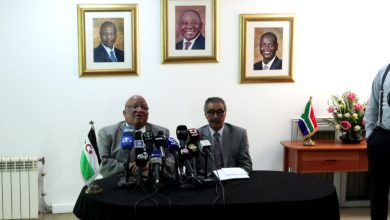حين يُحقن المجتمع بإبر الخوف، وتُورّث ذاكرة الألم كقدرٍ أعمى
في إحدى التجارب العلمية الغريبة، حُقنت ديدان تعيش في الظلام بإبرة مؤلمة كلّما خرجت إلى الضوء. ومع الوقت، توقفت تلك الديدان عن الخروج للضياء…
ما يثير الذهول ليس هذا السلوك وحده، بل أن صغار الديدان – التي لم تُحقن ولم تر الألم – ورثت الخوف ذاته. تجنبن الضوء دون أن يفهمن السبب، وكأن الوجع قد تسرّب إلى الحمض النووي، وكُتب الخنوع في الشيفرة الوراثية.
يبدو أن التجربة ليست بيولوجية فقط… بل تاريخية أيضًا.
الضوء كرمز… والظلام كسياسة
في مجتمعاتنا، هناك ضوء أيضًا. لكنه لا يأتي من الشمس، بل من المواقف. من الكلمة الصادقة، ومن الصوت الذي يعلو رغم الخطر. غير أن هذا الضوء أصبح منذ زمن محفوفًا بالإبر، يُوجع من يقترب منه، ويُطعن فيه كل من يحاول أن يراه. قادة قدامى حاولوا، تكلموا، نادوا بالعدل، ثم سقطوا في الظلام بعد طعنات متعددة: السجن، النفي، التشويه، أو الاغتيال المعنوي.
هؤلاء تركوا أثرًا… لكنه لم يكن بالضرورة الأثر المرجو. تمامًا كما حدث مع الديدان.
حين تتحول دروس البطولة إلى تركات خوف
ما حدث – في كثير من الأحيان – هو أن الذاكرة الجماعية لم ترسّخ الشجاعة، بل رسّخت الخوف. الأبناء لم يروا آباءهم وهم يقاومون، بل سمعوا عن نهاياتهم الحزينة. والنتيجة: أصبح الضوء شيئًا يتجنبه الجيل الجديد، لا لأنه مؤذٍ بطبعه، بل لأن هناك شيئًا في داخله يخبره أن “الاقتراب من الضوء مؤلم”.
سيكولوجيا الشعوب الموروثة
المجتمع الذي يُحكم بإبر الخوف، لن يحتاج مستقبله إلى ديكتاتور… بل سيكفيه أن يخاف من ديكتاتورٍ متخيل. وهذا أسوأ من الطغيان ذاته: أن يصبح الخوف من النور عادة. وأن يصبح الصمت “فضيلة اجتماعية”، والتراجع “حنكة سياسية”، والانسحاب من المعركة “واقعية عقلانية”
نحن نعيش اليوم في مجتمعات دودية الطابع، لا لأنها ضعيفة، بل لأنها خضعت لألمٍ قديم. والخطورة الكبرى أن الجيل الجديد لا يعرف النور حتى ليخافه… بل لم يره أصلًا.
الخوف الموروث أخطر من الطغيان. لأنه يُغلق النوافذ من الداخل.
وإذا لم نكسر دورة “الإبرة” هذه، فإن الضوء سيُصبح مجرد أسطورة تروى في الظلام.
زئبق … الخوف