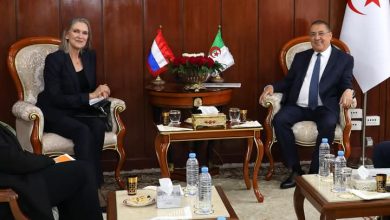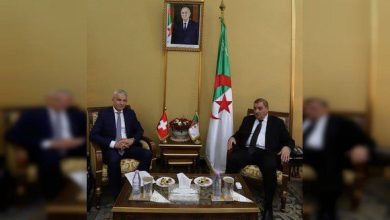في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار علاقة الجزائر بالمنظومة الحقوقية الأممية، صدر المرسوم الرئاسي رقم 25-218 المؤرخ في الرابع من أوت 2025، والقاضي برفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). خطوة لم تأتِ من فراغ، بل بعد ما يقارب ثلاثة عقود من إبقاء الجزائر تحفظها على هذا البند الذي يمنح المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في التنقل والسكن والإقامة.
التوقيت وحده يكفي لإثارة التساؤلات. فقد جاء القرار في قلب شهر أوت، حين انشغل أغلب الجزائريين بعطلتهم الصيفية، أو غارقين في همومهم اليومية بعيدًا عن متابعة المستجدات السياسية. اختيار لحظة الصمت الاجتماعي قد يكون مقصودًا لتقليل وقع الصدمة والجدل، ولتمرير المرسوم بعيدًا عن أعين الرأي العام المتأهب. وفي الوقت ذاته، لا يمكن فصل التوقيت عن الحسابات الدبلوماسية، إذ أن الجزائر تسعى إلى تحسين صورتها الخارجية في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق، مع تكثيف الضغوط الأممية المتكررة بشأن التحفظات على الاتفاقية.
من الناحية القانونية، القرار يعترف رسميًا بحق المرأة في حرية التنقل واختيار محل السكن مثل الرجل، وهو ما يضع الجزائر في انسجام أكبر مع المعايير الدولية لحقوق المرأة. غير أن هذا الاعتراف يفتح الباب لتناقضات صاخبة مع المنظومة التشريعية الوطنية، وفي مقدمتها قانون الأسرة الذي لا يزال يكرّس سلطة الزوج باعتباره “رئيس العائلة” وصاحب القرار في مسائل الإقامة. دستور 2020 الذي منح الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية يجعل البرلمان والقضاء أمام اختبار عسير: هل ستخضع النصوص المحلية لتعديلات جذرية؟
أما على المستوى الاجتماعي، فقد فجّر القرار انقسامًا قديمًا جديدًا. فالمؤيدون يعتبرونه انتصارًا طال انتظاره يعيد للمرأة استقلاليتها التي قُيّدت لعقود، فيما يراه المعارضون، وخاصة التيارات الإسلامية والمحافظة، تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسرة ومقدمة لارتفاع نسب الطلاق، التي تشهد أصلًا مستويات مثيرة للقلق. بالنسبة لهؤلاء، فإن القرار لا يتعلق بحقوق فردية بقدر ما يفتح الباب لصراع يومي داخل الأسرة حول من يقرر وأين يقيم الزوجان.
لكن ما يجعل الخطوة أكثر حساسية هو بعدها الأيديولوجي. فالنسويات يرون فيها بداية حقيقية لإعادة النظر في قانون الأسرة برمّته، بينما المحافظون يقرأونها كتسليم من الدولة أمام ضغوط الغرب ورضوخًا لمعايير ثقافية لا تنتمي إلى المجتمع الجزائري. وهكذا يتحول بند قانوني صغير إلى رمز كبير لمعركة الهوية بين تيارين: تيار حداثي يرفع شعار “المواطنة والمساواة”، وتيار تقليدي يعتبر الأسرة حصنًا أخيرًا أمام موجة العولمة الحقوقية.
المآلات المستقبلية تبقى مفتوحة على أكثر من احتمال. فمن المرجح أن تشتد السجالات في المدى القريب، سواء في الإعلام أو داخل قبة البرلمان أو حتى عبر احتجاجات في الشارع. وعلى المدى المتوسط، سيُطرح تعديل قانون الأسرة بشكل أكثر إلحاحًا، لتفادي التناقض بين النصوص الوطنية والالتزامات الدولية. أما على المدى البعيد، فقد يكون رفع هذا التحفظ خطوة أولى نحو سلسلة تنازلات أخرى، خاصة إذا استمرت الأمم المتحدة في مطالبة الجزائر برفع تحفظها عن المادة 16 المتعلقة بالأحوال الشخصية.
في النهاية، لا يمكن اختزال ما حدث في مرسوم تقني أو إجراء إداري بسيط. إنّه قرار سياسي وأيديولوجي بامتياز، يكشف حجم التوتر القائم بين التزامات الجزائر الدولية ومرجعيتها الإسلامية والوطنية. وبينما يصفه البعض بأنه انتصار تاريخي للمرأة الجزائرية، يراه آخرون بداية زلزال قد يعصف بالأسرة الجزائرية من الداخل. وإذا كان شهر أوت قد خفّف من وقع الصدمة على الرأي العام، فإنّ ارتداداتها لن تلبث أن تهزّ المشهد السياسي والاجتماعي لسنوات قادمة.
إن الدولة التي تتهاون في حماية ثوابتها وتترك جغرافياها للتلاعب، وتاريخها للمحو، ومجتمعها للتمزق، ستدفع الثمن غاليًا. فحينها لن تكون المدارس ملأى، ولا الجامعات مزدحمة، ولا المستشفيات مكتظة… بل ستُصبح المحاكم والسجون هي المؤسسات الأكثر امتلاءً في البلاد، لأن كل انحراف عن الهوية وكل اختراق للسيادة سيتحول إلى ملف قضائي أو نزاع دموي. وهذه ليست نبوءة، بل حقيقة يعرفها من يقرأ مسار الأمم التي خانت نفسها.